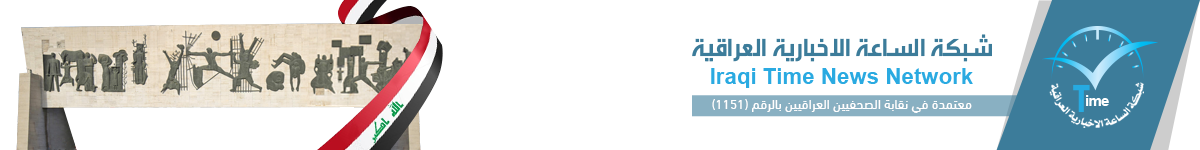مقالات
{الإيمان} و {العقل} في المسيحية والإسلام
بقلم: حبيب محمد هادي الصدر *
العلاقة بين (الإيمان) و(العقل) قد شغلت
حيزا كبيرا من اهتمامات الفلاسفة والمفكرين ورجال الدين على مر العصور
والأجيال، فبينما حاول (أرسطو) و(أفلاطون) تلمس مقاربات بين الاثنين وتشذيب
العقائد السائدة آنذاك من الخرافات والأساطير فقد سار على خطاهما فيما بعد
الفلاسفة العرب المسلمون، فمثلا عمد (إبن خلدون) إلى الفصل بين الإثنين
لعدم إمكان العقل إدراك قضايا إيمانية كالتوحيد والآخرة والوحي الإلهي
والصفات الربانية على العكس من (إبن رشد) الذي توسع في توظيف البراهين
العقلية لإثبات وجود الله “عز وجل”.
واتخذ القديس (توما الاكويني) الذي عاش في القرن الثالث عشر نفس هذا المسار
أما (مارتن لوثر) رائد الحركة البروتستانتية فكان يرى عبثية البحث عن
تبرير عقلي لمسألة دينية، لكن (ديكارت) أظهر استطاعته على إثبات وجود الله
عقليا ورياضيا في حين أن القديس (أوغسطين) ذهب إلى أن (الإيمان) لا يعتمد
على (العقل) بل (الإرادة). وحاول آباء كنيسة المشرق الأرثوذوكس مسحنة الفكر
الأفلاطوني على ضوء معطيات الوحي كــ(باسيليوس الكبير) وأخيه (غريغوريوس
النيصي) خاصة في موضوعات (خلود الروح) و (أصل الشر).
وحدث تغيّر حاسم في موقف الكنيسة الكاثوليكية الذي كان في بادىء الأمر
رافضا لخيار عقلنة الدين طوال القرون الوسطى معتبرا إياه ضربا من ضروب
الهرطقة ثم تحول لاحقا إلى المناشدة بإتباع (العقل) وإعماله في المسائل
الإيمانية سواء على صعيد استيعاب المضمون الإيماني أو على صعيد استنباط
الأحكام من النصوص المقدسة وتقريبها إلى الأفهام أو لإيجاد البراهين
المنطقية للدفاع عن الإيمان وتسويغه، حيث تكونت قناعات كاثوليكية بأن
(الإيمان) ليس بمقدوره لوحده اكتشاف حقائق التشريع ومقاصده النائية، ولأنه
سبحانه بعث إلينا حجتين إحداهما حجة (ظاهرة) يمكن إدراكها بعقولنا والأخرى
(باطنة) علينا إدراكها بــ (قلوبنا) أي بإيماننا الفطري وتسليمنا لمشيئته
سبحانه، مما يجعل (التضاد) بين (الإيمان) و(العقل) أمرا غير واقعي لأن عرض
الإيمان على العقل هو محاولة لتجذيره في النفوس وتنقيته من الشوائب وتوسيع
دخوله إلى جمهور المؤمنين.
وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار (الإيمان) و(العقل) هبتين ربانيتين إلى
الإنسانية مع جواز تفوق (الإيمان) في بعض الحالات على (العقل) كونه السبيل
الوحيد لتصديق ما لانراه بأعيننا. لكن لا ينبغي أن يكون (الإيمان) مشروطا
بـ (العقل) وبهذا الخصوص أوضح البابا الراحل (يوحنا بولص الثاني) في رسالته
المؤرخة في (14/ أيلول/ 1998) بأن هناك طريقين متكاملين للوصول إلى
الحقيقة وهما (الإيمان) و(العقل) فيما اعتبر (آباء المجمع الفاتيكاني
الثاني) آلام المسيح وأفعاله وموته وقيامته هي الجواب الحقيقي على أسئلة
العقل حول الخلق والموت والآخرة والحساب وما شاكلها.
أما القديس (بولص) فقد شدد في وصاياه على أن الله قد زرع في عمق كل إنسان
توقا وحنينا إلى الله وباستطاعته أن يظفر بالحقيقة بواسطة (البحث العقلي)
وأيضا بواسطة الوثوق بأشخاص بإمكانهم أن يضمنوا له يقينها وسلامتها.
ومما تجدر الإشارة إليه أن العصر الحديث شهد ظهور تيارات إلحادية لا تؤمن
إلا بـ (العقل) وتزدري بالقيم الإيمانية الغيبية الميتافيزيقية كـ
(الماركسية) و(الوجودية) مما وضع (المسيحية والإسلام) على حد سواء أمام تحد
مشترك حيث اعتبر مراجع المسلمين كأئمة الأزهر الشريف وكالإمام المرجع
الشيعي الكبير الراحل (آية الله العظمى السيد محسن الحكيم) (قدس سرّه) أن
الشيوعية كفر وإلحاد فيما أدان البابا (بيوس الحادي عشر) رسميا الماركسية
وحذر البابا (بيوس الثاني عشر) من التأويلات الزائفة لنظرية التطور
الداروينية ولا ننسى مناداة البابا (ليون الثالث عشر) بالعودة إلى فكر
(توما الاكويني) والتأسيس لتوجه (فلسفي – لاهوتي) متنور وواع جديد قادر على
الخوض في الأسرار وماهية المسيح والعلاقة بين الله والإنسان، ويحظى
بمقبولية لدى المؤمنين وغيرهم، وهذا اللاهوت المعاصر لا بد له أن ينهل من
العلوم التطبيقية والإنسانية وينفتح على الثراء الروحي للأديان الأخرى عبر
القنوات الحوارية التواصلية بلوغا إلى (الحقيقة الموضوعية) بجميع تجلياتها
وتطويع نتائجها لخدمة الإنسان والمجتمع.
وبديهي أن يرشح عن عقلنة الإيمان ظهور بوادر لــ (الاختلاف) في فهم الحقائق
والأحكام وليس هذا عيبا أو منقصة بل هو حق مكفول للجميع وهو يشكل مصدر غنى
للفكر الإنساني فضلا عن تحفيزه أتباع الديانات السماوية لإطلاق حوارات
مثمرة حرة تقوم على أساس القواسم الإيمانية المشتركة مع الآخر واحترامه
والاعتراف به شريكا كاملا، وهي قواسم من شأنها الخروج بمواقف موحدة إزاء
التحديات الكونية المشتركة وفي مقدمتها تفشي التطرف والإرهاب والصراعات
المسلحة والأزمة الاقتصادية والتغير المناخي والاتجار بالبشر وكل أشكال
الإنتهاكات للحريات وحقوق الإنسان وعلى رأسها الحرية الدينية وحرية الضمير
والمعتقد واختيار الدين عن قناعة ودون إكراه واستنكار أي فعل مسيء يستهدف
النيل من الرموز الدينية المقدسة واحترام قدسية الحياة الإنسانية وتكريس
مفاهيم العيش التسامحي المشترك العابر للإثنيات والمذاهب والأديان، وتجنب
(التعميم) و(الإنتقائية) عند نقد العقائد الأخرى وتبني الرؤية الشاملة
الإيجابية الخالية من الأحكام الجائرة المسبقة ، والترويج لفكرة تشريع
مدونة سلوك أخلاقية أممية تتولى تطبيق مضامينها منظمة دولية على غرار منظمة
حقوق الإنسان تتبع هيئة الأمم المتحدة بغية إرساء نظم وضوابط إنسانية
للتعامل الأخلاقي بين الشعوب واديان كاحترام العقائد وضمان الحريات الدينية
وتحريم النزاعات الطائفية وعدم تسويغ العنف بأغطية دينية وما شاكلها
وتجسيد الجوهر التسامحي الاعتدالي للقيم القرآنية والإنجيلية عبر وسائل
الإعلام والمناهج الدراسية وتنظيم المعارض العلمية والمهرجانات الفنية
والمؤتمرات النقاشية والدفع باتجاه تشريع القوانين الضامنة لحقوق الأقليات
الدينية.
وما دام التفاعل والتكامل بين (الإيمان) و(العقل) أمرا توافقيا أقرته
المرجعيات الدينية الإسلامية والكاثوليكية معا فلا بد إذن أن يترجم هذا
الانهماك المشترك إلى مادة حيوية لتعزيز آفاق العمل الثنائية الممكنة. ذاك
لأن (العقل) هو أحد أهم مصادر التشريع في الإسلام بعد (القرآن لكريم)
و(السنة النبوية الشريفة) ولأنه يعد مناطا للتكليف وبه ميز الله (الإنسان)
عن سائر مخلوقاته وبنوره أمكن إدراك إعجاز القرآن كقول نبينا “ص”: (ما كسب
أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى). وكقوله تعالى: (هل
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) الزمر /9.
وكقوله سبحانه: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)
العنكبوت / 43. وكقوله “جل وعلا”: (ويريكم آياته لعلكم تعقلون) البقرة/73
وقوله تعالى: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون) الجاثية/ 13. كما أوصى الأئمة الأطهار “ع” أتباعهم بعدم
قبول أي حديث ينسب إليهم إلا بعد تمحيصه عقليا والتأكد من عدم تقاطعه مع
النصوص المقدسة.
*سفير جمهورية العراق
لدى الفاتيكان
العلاقة بين (الإيمان) و(العقل) قد شغلت
حيزا كبيرا من اهتمامات الفلاسفة والمفكرين ورجال الدين على مر العصور
والأجيال، فبينما حاول (أرسطو) و(أفلاطون) تلمس مقاربات بين الاثنين وتشذيب
العقائد السائدة آنذاك من الخرافات والأساطير فقد سار على خطاهما فيما بعد
الفلاسفة العرب المسلمون، فمثلا عمد (إبن خلدون) إلى الفصل بين الإثنين
لعدم إمكان العقل إدراك قضايا إيمانية كالتوحيد والآخرة والوحي الإلهي
والصفات الربانية على العكس من (إبن رشد) الذي توسع في توظيف البراهين
العقلية لإثبات وجود الله “عز وجل”.
واتخذ القديس (توما الاكويني) الذي عاش في القرن الثالث عشر نفس هذا المسار
أما (مارتن لوثر) رائد الحركة البروتستانتية فكان يرى عبثية البحث عن
تبرير عقلي لمسألة دينية، لكن (ديكارت) أظهر استطاعته على إثبات وجود الله
عقليا ورياضيا في حين أن القديس (أوغسطين) ذهب إلى أن (الإيمان) لا يعتمد
على (العقل) بل (الإرادة). وحاول آباء كنيسة المشرق الأرثوذوكس مسحنة الفكر
الأفلاطوني على ضوء معطيات الوحي كــ(باسيليوس الكبير) وأخيه (غريغوريوس
النيصي) خاصة في موضوعات (خلود الروح) و (أصل الشر).
وحدث تغيّر حاسم في موقف الكنيسة الكاثوليكية الذي كان في بادىء الأمر
رافضا لخيار عقلنة الدين طوال القرون الوسطى معتبرا إياه ضربا من ضروب
الهرطقة ثم تحول لاحقا إلى المناشدة بإتباع (العقل) وإعماله في المسائل
الإيمانية سواء على صعيد استيعاب المضمون الإيماني أو على صعيد استنباط
الأحكام من النصوص المقدسة وتقريبها إلى الأفهام أو لإيجاد البراهين
المنطقية للدفاع عن الإيمان وتسويغه، حيث تكونت قناعات كاثوليكية بأن
(الإيمان) ليس بمقدوره لوحده اكتشاف حقائق التشريع ومقاصده النائية، ولأنه
سبحانه بعث إلينا حجتين إحداهما حجة (ظاهرة) يمكن إدراكها بعقولنا والأخرى
(باطنة) علينا إدراكها بــ (قلوبنا) أي بإيماننا الفطري وتسليمنا لمشيئته
سبحانه، مما يجعل (التضاد) بين (الإيمان) و(العقل) أمرا غير واقعي لأن عرض
الإيمان على العقل هو محاولة لتجذيره في النفوس وتنقيته من الشوائب وتوسيع
دخوله إلى جمهور المؤمنين.
وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار (الإيمان) و(العقل) هبتين ربانيتين إلى
الإنسانية مع جواز تفوق (الإيمان) في بعض الحالات على (العقل) كونه السبيل
الوحيد لتصديق ما لانراه بأعيننا. لكن لا ينبغي أن يكون (الإيمان) مشروطا
بـ (العقل) وبهذا الخصوص أوضح البابا الراحل (يوحنا بولص الثاني) في رسالته
المؤرخة في (14/ أيلول/ 1998) بأن هناك طريقين متكاملين للوصول إلى
الحقيقة وهما (الإيمان) و(العقل) فيما اعتبر (آباء المجمع الفاتيكاني
الثاني) آلام المسيح وأفعاله وموته وقيامته هي الجواب الحقيقي على أسئلة
العقل حول الخلق والموت والآخرة والحساب وما شاكلها.
أما القديس (بولص) فقد شدد في وصاياه على أن الله قد زرع في عمق كل إنسان
توقا وحنينا إلى الله وباستطاعته أن يظفر بالحقيقة بواسطة (البحث العقلي)
وأيضا بواسطة الوثوق بأشخاص بإمكانهم أن يضمنوا له يقينها وسلامتها.
ومما تجدر الإشارة إليه أن العصر الحديث شهد ظهور تيارات إلحادية لا تؤمن
إلا بـ (العقل) وتزدري بالقيم الإيمانية الغيبية الميتافيزيقية كـ
(الماركسية) و(الوجودية) مما وضع (المسيحية والإسلام) على حد سواء أمام تحد
مشترك حيث اعتبر مراجع المسلمين كأئمة الأزهر الشريف وكالإمام المرجع
الشيعي الكبير الراحل (آية الله العظمى السيد محسن الحكيم) (قدس سرّه) أن
الشيوعية كفر وإلحاد فيما أدان البابا (بيوس الحادي عشر) رسميا الماركسية
وحذر البابا (بيوس الثاني عشر) من التأويلات الزائفة لنظرية التطور
الداروينية ولا ننسى مناداة البابا (ليون الثالث عشر) بالعودة إلى فكر
(توما الاكويني) والتأسيس لتوجه (فلسفي – لاهوتي) متنور وواع جديد قادر على
الخوض في الأسرار وماهية المسيح والعلاقة بين الله والإنسان، ويحظى
بمقبولية لدى المؤمنين وغيرهم، وهذا اللاهوت المعاصر لا بد له أن ينهل من
العلوم التطبيقية والإنسانية وينفتح على الثراء الروحي للأديان الأخرى عبر
القنوات الحوارية التواصلية بلوغا إلى (الحقيقة الموضوعية) بجميع تجلياتها
وتطويع نتائجها لخدمة الإنسان والمجتمع.
وبديهي أن يرشح عن عقلنة الإيمان ظهور بوادر لــ (الاختلاف) في فهم الحقائق
والأحكام وليس هذا عيبا أو منقصة بل هو حق مكفول للجميع وهو يشكل مصدر غنى
للفكر الإنساني فضلا عن تحفيزه أتباع الديانات السماوية لإطلاق حوارات
مثمرة حرة تقوم على أساس القواسم الإيمانية المشتركة مع الآخر واحترامه
والاعتراف به شريكا كاملا، وهي قواسم من شأنها الخروج بمواقف موحدة إزاء
التحديات الكونية المشتركة وفي مقدمتها تفشي التطرف والإرهاب والصراعات
المسلحة والأزمة الاقتصادية والتغير المناخي والاتجار بالبشر وكل أشكال
الإنتهاكات للحريات وحقوق الإنسان وعلى رأسها الحرية الدينية وحرية الضمير
والمعتقد واختيار الدين عن قناعة ودون إكراه واستنكار أي فعل مسيء يستهدف
النيل من الرموز الدينية المقدسة واحترام قدسية الحياة الإنسانية وتكريس
مفاهيم العيش التسامحي المشترك العابر للإثنيات والمذاهب والأديان، وتجنب
(التعميم) و(الإنتقائية) عند نقد العقائد الأخرى وتبني الرؤية الشاملة
الإيجابية الخالية من الأحكام الجائرة المسبقة ، والترويج لفكرة تشريع
مدونة سلوك أخلاقية أممية تتولى تطبيق مضامينها منظمة دولية على غرار منظمة
حقوق الإنسان تتبع هيئة الأمم المتحدة بغية إرساء نظم وضوابط إنسانية
للتعامل الأخلاقي بين الشعوب واديان كاحترام العقائد وضمان الحريات الدينية
وتحريم النزاعات الطائفية وعدم تسويغ العنف بأغطية دينية وما شاكلها
وتجسيد الجوهر التسامحي الاعتدالي للقيم القرآنية والإنجيلية عبر وسائل
الإعلام والمناهج الدراسية وتنظيم المعارض العلمية والمهرجانات الفنية
والمؤتمرات النقاشية والدفع باتجاه تشريع القوانين الضامنة لحقوق الأقليات
الدينية.
وما دام التفاعل والتكامل بين (الإيمان) و(العقل) أمرا توافقيا أقرته
المرجعيات الدينية الإسلامية والكاثوليكية معا فلا بد إذن أن يترجم هذا
الانهماك المشترك إلى مادة حيوية لتعزيز آفاق العمل الثنائية الممكنة. ذاك
لأن (العقل) هو أحد أهم مصادر التشريع في الإسلام بعد (القرآن لكريم)
و(السنة النبوية الشريفة) ولأنه يعد مناطا للتكليف وبه ميز الله (الإنسان)
عن سائر مخلوقاته وبنوره أمكن إدراك إعجاز القرآن كقول نبينا “ص”: (ما كسب
أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى). وكقوله تعالى: (هل
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) الزمر /9.
وكقوله سبحانه: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)
العنكبوت / 43. وكقوله “جل وعلا”: (ويريكم آياته لعلكم تعقلون) البقرة/73
وقوله تعالى: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون) الجاثية/ 13. كما أوصى الأئمة الأطهار “ع” أتباعهم بعدم
قبول أي حديث ينسب إليهم إلا بعد تمحيصه عقليا والتأكد من عدم تقاطعه مع
النصوص المقدسة.
*سفير جمهورية العراق
لدى الفاتيكان