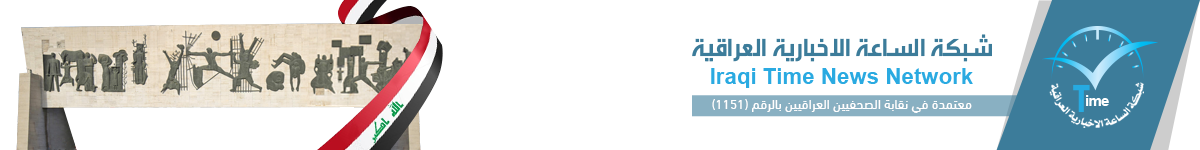رسائل النهر
الكدح اليومي من أجل لقمة العيش والدفاع عن النفس، والثانية حياةُ السّفر
والحلم والحكايات. ففي نهاية يوم من الزحام البشري وتصادم الوجوه والنظرات،
تخلو الروحُ الشقية إلى أحلامها فتطير بعد زحفٍ طويل في الأسواق والمقاهي
والدوائر الواطئة السُّقوف. وجها الحياة المتلاصقان هذان، يوردان الجسدَ
العراقيّ أوشالَ الأنهار الراكدة، أو يرفعانه إلى منابع الرؤيا؛ يرميانه في
وادي الأعصاب والدماء والأفكار المحتدمة، أو يأخذانه إلى وادي السلام
المكفَّن بالصمت الأبدي.
هذا الانقسام ليس حالة طارئة في حياة العراقيين، إنّه الحراك الأكثر
تعبيراً عن الطبيعة المزدوجة التي طبَعَت التاريخَ المتقلّب للدولة
العراقية بطابعها، ووسَمَت المجتمعَ المدنيّ والقبليّ بميسمها الذي لا يزول
أثره، بل تتعمّق ألوانُه بالانتقال من وضع سابق إلى وضع لاحق. وليس في هذا
الانقلاب والاضطراب تقديرٌ مقدَّر على شعب عاجز ومقيّد، ولكنْ إيحاءٌ
برسائل طبيعةٍ تنتشر كجذور (شجرة آدم) في أرض الأنبياء، وتجري كجريان
نهرينِ متعانقينِ في لاوعي الخليقة الرافدينية.
في التقدُّم إلى أمام، خلال التاريخ العظيم لشعب وادي الرافدين، رجوعٌ
عكسيّ إلى نقطة الصِّفر (صفر الدولة)، إلى نقطة التأمّل في التكوين
العجائبيّ لكائنٍ يساوم على حياته الثمينة في أسواق الغرور بأبخس الأثمان،
ويُلقي بروحه الطيبة في أتون الصراعات المرحلية، ثم يذهب إلى فراشه حالماً
بمستقبل قد لا يتحقّق في أيّ وجه من الوجوه، بأسلوب سرديات (بخلاء) الجاحظ
الساخرة، أو (مقامات) أبي زيد السروجي الماكرة، وخيال الحكايات البغدادية
والسندبادية الجامحة: كلّ تأليف سردي معقول ينطوي على قدر كبير من النقائض
والتلفيقات بنسبة غير معقولة.
سُقتُ هذه المقدمات اضطراراً لأبدأ قيامتي الطبيعية في مسقط رأسي، وتحريرَ
رسالتي القصصية من نشأتي، جوار نهر صغير في مدينة الحكايات وثغْر المتحدثين
والمخترعين وغارسي النخيل وكابسي التمور، والراقصين والحُواة والمهرّجين
واللاعبين بنرْد الحظّ في ظلال الشرفات الخشبية، البيضِ والسُمْر والزِنْج
والزّطّ، عبيدِ الشُطوط وآلهةِ الملاريا. وما زلت أشجّع نفسي على موافقة
النقائض للأحوال المتبدلة، لكيما أتردّى في المثال، الذي يتراءى نقياً،
فينكشف زيفُه في لحظة الاختبار الأول في سوق القراءة والتأويل.
آنذاك، أيام الدراسة في ثانوية (العشار)، اعتدْتُ التجوال على ساحل صخريّ
يغمره المدُّ، فألتقطُ رسائلَ التمرد التي تلقي بها أبراجُ السفن المحيطية
نحوه؛ ويجرّده الجَزْرُ من ثوبه الأخضر، فأُنصِتُ لأغاني الصمت والحنين في
ثقوب سراطينِه. وبين المدّ والجزْر أُلوِّحُ للأجساد المسفوعة على
(الأبوام) الراسية، محترقاً بشمس البحار وسؤالِ السّفر وعجبِ الحِبال
الملتفّة حول صارٍ شاهق يثقب زرقةَ السماء، ثم أنسحبُ إلى عمقي الداخلي
ملتحماً بأقدار المنتظرين عند عتبات منازلهم، مودِّعاً المتونَ المهاجرة
المتروكة على ساحل الصخور المثقَّبة. ولم أعتقد يوماً بأن نصّاً يولد من
غير قدرةٍ على الهجرة عبر لغته الأصلية إلى عدد غير محدود من اللغات.
كانت قصص مكسيم غوركي ترصُّني في خلايا الحياة اليومية المعانِدة، بينما
تناديني صخورُ الساحل للإصغاء إلى رسائل الحُكاة السُّمر الطليقة. كان
الذهاب إلى مملكة الرسائل النهرية يمرُّ بأزقةٍ وشرفات وعربات ونوافذ واطئة
ومزابل ودكاكين وسُبُل ماء وسراديب، شحاذين ومشردين وحلاقين وفوّالين،
نداءاتٍ وأغانٍ وشهقات تمتزج بالصدى المتلاطم لدروس التاريخ العراقي بين
جدران “المدرسة الثانوية” العشرينية السميكة، ثم تذوب شيئاً فشيئاً في
هسهسات الماء في ثقوب الصخور التي حفرتْها السراطينُ في جرف النهر. كان
العالم يحضر بكلّيته المعجمية في هسهسة غير مفكوكة، ولا مفسَّرة، عند مدرسة
النهر الخضراء.(أتذكر أن قصة، بعنوان: شجرة الأسماء، كانت مُطلسَمة برموز
صندوقٍ أثري، ألقت به سفينة قادمة من الجُزُر السرنديبية).
استطالَ ذلك الزمان الأخضر سنوات، ودفعت غرغراتُ الثقوب برسائل المملكة
النهرية الأخيرة، ثم انطبق الأفقُ المحدَّب مثل تِرْس سلحفاةٍ منذراً
باقتراب سُحُب الحرب، وغدا انتزاع قصةٍ جديدة من ساحل مرصوصٍ بالنُذُر
والتوقعات مرهقاً للمخيّلة الحسّاسة لأخفتِ الأصوات وأضألِ الحركات. احتجزَ
النهرُ السفنَ السندباديّة بسلاسله الصدئة، وسدّت متاريسُ الأكياس
الرمليّة الطرقاتِ إلى النهر، وكانت طحالب الواقع المتشابكة تفرز سـائلاً
لزجـاً زفراً، ثم تفسّـخَت أصواتُ الأبدية الحاكية في ثقوب السَّرطان
وانقطعت الرسائل.
أتذكّرُ أياماً كان الخروج فيها إلى صخور الشاطئ واعداً بهِباتٍ تافهة
طافية مع الأسماك الميتة، وأصداءُ مدافع بعيدة وراء الضفة الشرقية تذوب في
صليل الأغاني الهستيرية وفوضى الأصوات البشرية المنسحبة إلى ملاجئها. ما أن
تقترب ساعة الغروب حتى يعود السيلُ البشري إلى ثقوبه المنزلية ويسبِتُ مع
ثعابين أحلامه، فلا يُسمَع في الشوارع المقفرة غيرُ أنين الأرواح الزائرة،
تطرق الأبوابَ المقفلة وتسأل الدخولَ والحماية. كان إيواء هذا الأنين
الشارد من الحرب ومسامرته في عمل سرديّ يخفف من الشعور بالذنب لمشاركةٍ
صامتة في قتال لا تبدو له نهاية، تقذف طاحونتُه بالمعاقين والمخبولين
والهاربين في كلّ صباح جديد. عاماً بعد عام، امتدَّت أمامَ ساحل النصوص
مراسٍ طويلة للسفن المحطمة، العاطلة عن السفر، صدِئتْ وتقشَّرتْ وسكنتْها
الأشباح. وكان العثور على ثقب سرطانٍ يلفظ رسائلَه الحاكية معجزةً من
معجزات الرؤى الخُضر الهاربة من أزمنة الحرب. انبثقت قصةُ (رؤيا خريف) من
ثُقب سرطان, في جوّ كابوسيّ, سبقَ عبورَ الشاحنات العسكرية إلى الضفة
الأخرى على جسر حديديّ نُصِب تحت جنح الليل في خريف العام 1980. وما زالت
قشعريرة كتابة هذه القصة تعتريني كلما تذكّرتُ هديرَ قافلة الشاحنات
المتصلة، وصليلَ سلاسل الجسر المتماوج تحت ثقل الجنود والسلاح، يكتمان
هسهساتِ المياه وغرغرتَها وأنّاتها في ثقوب الجرف الصخري.
كمْ أتوقُ أكثر من ذي قبل، في فوضى الزحام البشري اليومي، إلى سماع تلك
الرسـائل المغرغِرة، واسـتعادةِ نصف حياتـي المفقود من أعماق الثقوب الخضر،
وصوغِ (( بيانات)) أُرسلُها إلى سواحل الممالك البحرية السعيدة، بفرح
كبير.ثقوب ستنشأ في ذاكرة الجنود، وجسور كثيرة ستنقلهم إلى عالم جديد وراء
حدود الجمهورية وداخلها، وسيحين الوقت دائماً لكتابة نصّ جديد، من وحي
السراطين النهرية، رسائل لا تنقطع مع أي نفير وتحت ضغط سرفات مزمجرة، في أي
مناخ نهريّ رطب.