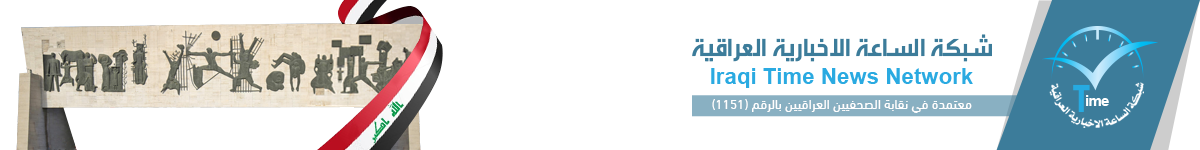الاخبار
العبادي يلغي 11 منصبا في الحكومة العراقية
بغداد/ شبكه الساعه الاخباريه العراقيه.
ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن
حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان
لمكتبه الاعلامي الاحد.
وجاء في البيان “بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78
من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب ما يأتي: تقليص عدد اعضاء
مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا”،
وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات،
ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا فقط.هذا ومن جهة اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء “سياسيين
فاسدين” بمحاولة تخريب خطته الرامية لإجراء إصلاحات جذرية في النظام
الحكومي، وحذر زعماء مجموعات شيعية ذوي نفوذ من استخدام أتباعهم المسلحين
لتحقيق غايات سياسية.وأعلن العبادي بعد عام في منصب كرئيس لدولة العراق الغارقة في الفوضى
والفساد -أعلن- عن أكبر إصلاحات للنظام السياسي منذ انتهى الاحتلال العسكري
الأمريكي لبلاده، وذلك بطرح حزمة إجراءات للحد من استشراء الفساد في
مؤسسات الدولة، والاستجابة لمطالب الشعب العراقي الذي احتج على أوضاع البلد
المزرية.
ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن
حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان
لمكتبه الاعلامي الاحد.
وجاء في البيان “بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78
من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب ما يأتي: تقليص عدد اعضاء
مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا”،
وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات،
ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا فقط.هذا ومن جهة اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء “سياسيين
فاسدين” بمحاولة تخريب خطته الرامية لإجراء إصلاحات جذرية في النظام
الحكومي، وحذر زعماء مجموعات شيعية ذوي نفوذ من استخدام أتباعهم المسلحين
لتحقيق غايات سياسية.وأعلن العبادي بعد عام في منصب كرئيس لدولة العراق الغارقة في الفوضى
والفساد -أعلن- عن أكبر إصلاحات للنظام السياسي منذ انتهى الاحتلال العسكري
الأمريكي لبلاده، وذلك بطرح حزمة إجراءات للحد من استشراء الفساد في
مؤسسات الدولة، والاستجابة لمطالب الشعب العراقي الذي احتج على أوضاع البلد
المزرية.