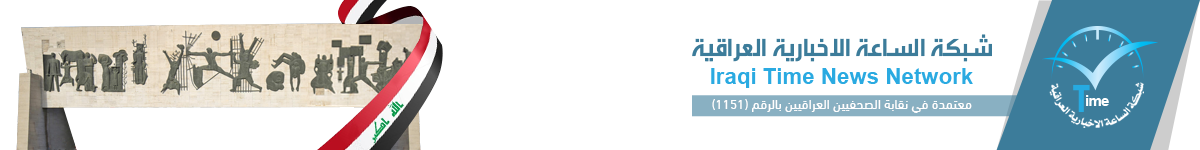رياضة محلية
غانا تواجه السنغال وجنوب أفريقيا تلتقي الجزائر في كأس الأمم الأفريقية
تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في غينيا الإستوائية، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المنافسات إذ تلتقي غانا المنتخب السنغالي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، فيما يلتقي في المجموعة ذاتها المنتخبان الجنوب أفريقي والجزائري.
ففي ملعب مونجومو يلتقي المنتخب الغاني نظيره السنغالي في الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد في إطار المجموعة الثالثة في مباراة يقودها الطاقم التحكيمي المؤلف من بيرنارد كاميل ويساعده كل من بيتر إيديبي وحسن ياسين.
وفي مباراة أخرى على نفس الملعب ضمن المجموعة ذاتها يلتقي منتخب جنوب أفريقيا نظيره الجزائري في في الساعة العاشرة بتوقيت بغداد بقيادة طاقم تحكيم مؤلف من تومانديز دوي وبمساعدة سونجويو وجون بيرو موشاهو.