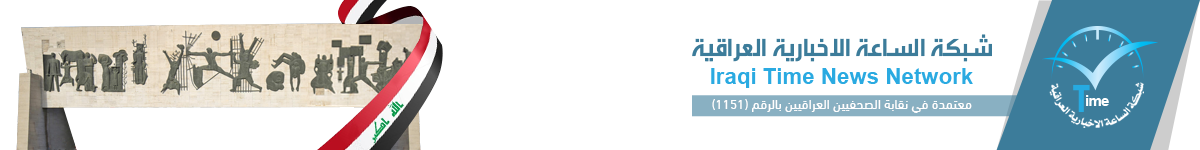سعد الياسري: أنا متصالحٌ مع حقيقة أنني شاعرٌ بلا وطن

• ست مجموعات شعرية صدرت لك حتى الآن، وما زال الشعر يأكل من يديك وقلبك… ما الذي تغير في سعد الياسري؛ شِعراً وروحاً، منذ صدور مجموعتك الأولى، “المنسأة”، وحتى مجموعتك السادسة، “الكرمة”؟
– بل قُل ما الذي لم يتغير! لم يبقَ من الطفل الذي كنتُه الكثير، حتى اللحظة التي اشتعلتْ قبل خمس عشرة سنة، وظننتُ حينها بأنَّ كلَّ شيءٍ صار ناضجاً، أراها اليوم غير ذات قيمة، إذ لا يوجد شيءٌ ناضجٌ في واقع الأمر، ولا لحظة مناسبة لقول ما لا يُقال… بعد ست مجموعات شِعرية؛ ما زلتُ أحدس كثيرًا، وأنخرُ بإصبعي السبَّابة الجدارَ… كي أرى، ولا أرى للأسف… لكنني مدجَّجٌ بالعزيمة، على مذهب (تينيسون) أردِّدُ: “لو فهمتُ زهرةً… سأفهمُ الكونَ كلَّه”.
• ولكن، ما الجديد الذي ستسعى للخروج به بعد كل هذا؟ وكيف بوسع الشعر أن يغير ويؤثر؟ وهل سيبقى الشِعر عالمك الأثير، أم أن أجناساً أخرى ستستدرجكَ؟
– هذا سؤال كبير، وتشعباته أوضح من استقامته. في الواقع، لستُ رساليّاً بما يخصُّ الكتابة، وأقترب من رأي الراحل الماغوط، في قوله: “لا يهمُّني أن أغيِّر العالم. ولم أحاولْ أن أنخرطَ في أيِّ حركةٍ من أجل تغيير العالم”… كما وكنتُ كثيرًا ما أخرج عن سياق النمطي؛ موبخاً الشِعر وسواه من الفنون التي ما استطاعت حسم نزاع في حانة بين ثملين اثنين لا أكثر. كما أنني لستُ مولعًا بما قد يكون، أنا في الذي هو كائن، لا أطيق العيش في التاريخ وكذلك أنفر من النزوع إلى وهم القادم… أنا أكتب لأخرج من لحظتي الراهنة بأقل قدر من الخدوش، ولا عناية عندي بسوى ذلك. لا أدري ما الذي سيأتي به الغدُ، ولا رغبة لي بطرق الحصى، لكنني مقيم في منزلي الشِعري حتى النهاية، وإن حدث واستأجرت منزلاً آخرَ؛ ربَّما الرواية، فلن يكون ذلك أكثر من إطلالة سائح ملول، سرعان ما سيعود إلى شرفته ووسادته وفوضاه المرتبة… أعني المرتبة بعناية فائقة!
• حاولت، في أغلب نصوصك، أن تطير مع الحلم… المرأة الحلم، السكنى الحلم، الغابة الحلم، حتى آخر حلم لم تتوصل إليه بعد. كيف يستطيع الشاعر أن يبني عالماً مغايراً بعيداً عن الواقع؟ وما الذي يجعل منه مرتبطاً بعوالمه الخاصة واللغوية؟
– قصائدي أناي، ولم أكن بعيدًا عن واقعي حين تحدثتُ عن المرأة والوطن والسكنى والغابة، والحلم أيضًا. تلك هي ميزة الشِعر برأيي، إنه يتيح لنا كشعراء تصدير واقعنا– لا تجميله وليس افتعاله بالتأكيد– بإشراقةٍ ما، قد يحسبها الآخر حلمًا، وسواه لا يرونها أصلاً، وآخرون يعتقدونها لحظة الحقيقة. تلك هي ميزة الشِعر، فأنا أحتقر عبارة “أعذب الشعر أكذبه”، وكل المؤمنين بها يثيرون ريبتي… فإن لم تكن ممتزجًا بنصِّكَ، وبنسبة مرتفعة من الصدق، لن تخرج بأكثر من أوهام. والشعر– كما تعلم- ليس وهمًا ولا حلمًا، الشِعر “الجيد” واقع وحقيقة نكتبها بلغة حالمة… وثمَّة فرق هائل بين المعنيين.
• للشعر احتمالات لا تعد، كيف نفهم ماذا يعني الشعر لديك؟ وما المؤثرات التي جعلت منك شاعراً أولاً، وكيف أثرت في نصك وأثرته؟
– لقد عبَّرتُ عن الشِّعرِ مرَّةً بالقول: “الشِّعرُ لا يُشبهُ الوقتَ. لانَّه خنجرُ السُّؤالِ، وطعنةُ الإجابةِ، والمدينةُ والغَجرُ، والطَّائرُ والبنادقُ، وكفُّ الصغيرِ قابضةً على إصبعيْ أمِّه وأبيهِ، والحبيبةُ راضيةً وغاضبةْ، ودمعةُ البشريةِ المالحة. لأنَّ الحياةَ شِعرٌ… والموتَ ليسَ بشاعر!”.
أيضًا، لا أحد يختار الشِعر، وليس بوسع أحدٍ أن يدرس أسبابه، لأنه– أي الشِعر- أعلى من العِلم، وأذكى من المنطق. لقد أثَّر بي نصِّي حين أجبرني على لفظه خارجي كورم فاضح، وأثرتُ فيه حين جعلتُ وجهي قناعه، وشفتيَّ قبلته، وأصابعي بناته… فإن لم يصلح لهكذا مهمة… لن يكون نصِّي!
• حياتك حقيبةُ سفرٍ تدور في مطارات العالم… من القاهرة إلى بغداد نحو ليبيا ثم السويد وأخيراً مستقرُّك في الكويت، كيف نفهم سلطة هذا السفر على بنية ولغة القصيدة؟ وإلى أي حد تأثرت لغتك بتشكل الأمكنة وتكونها في مخيلتك الشعرية؟
– تحدثتُ مرَّةً بإسهاب عن هذا الأمر، وقلتُ ما معناه: لا أدري كيف سيبدو الأمر لمن لم يعش هذا التنوُّعَ والتشتُّتَ في آنٍ، ولكنَّه بالنسبةِ إليَّ شكَّلَ إثراءً، وشذَّبَ سريرتي وقوَّمَ أعوجاج روحي. أنا متصالحٌ مع حقيقة أنَّني شاعرٌ بلا وطنٍ، ووطني- الجغرافيُّ على الأقلِّ- يحترقُ أمامي كلَّ يومٍ. وهذا يمنحني– للمفارقة– وطنًا شعريًّا رديفًا، لا يعترف بخطوط الطول والعرض، ولا ببرك الدماء، ولا بالسيوف والرقاب. إنه وطن من صنيعتي؛ وطن على هيئة قصيدة تعتمل بكل هذه الفقدانات المؤلمة.
بالنسبة إلى اللغة والجغرافيا، فتلك مسألة ينحاز لها الناقد لا الشاعر، ولا يعنيني القول فيها، بل ليس بوسعي أن أدلَّكَ إلى علامات ودلائل هذا التأثير؛ فيما لو كان موجودًا، ولعله كذلك؛ إنما فقط متابع نصوصي سيسعه أن يرصد أجواء أو مفردات تنزاح خارج نسق قاموسها المحلي والعربي ربَّما، وليس في ذلك ريادة ولا سبق، إنَّما حضور بلا فجاجة لأجل الحضور فقط، ولأنَّ استدعاءها جزء من لاوعي الناص ونصه… بالمناسبة، أحيانًا بوسعك أن تلمس ساق السويد، الأربعينية الفاحشة، في نصي الحافل بالحنين العراقي. إنَّها مقاربة شكلية وحسب!
• الضوضاء الثقافية التي نعيش فيها، جعلت من الأدب عائماً في فضاء لا يمثله، كيف يمكن أن يتميز شاعر وسط هذا الضجيج، وما الذي يجعل الشاعر ينسحب إلى نفسه في وسط يضج بالقطيع؟
– هذا يعيدُنا إلى سؤال سابق، أجبتُ عبر طرف فيه حول أمر مشابه. وأوافقك إلى حد كبير، خاصَّة وأنِّي أؤمن بـ “الفرد” ولا أرى في “الحشد” فضيلة. عمومًا، الأدب ليس له تأثير حقيقي وجاد في المجتمع، لا شِعرًا ولا نثرًا ولا سردًا ولا حتَّى مقالاً صحفيًّا. بالتالي، لا يمكن الفرز والإحالة إلى متميز وأقل تميزًا وجيد وأقل جودة وعادي ورديء… إلخ. إنَّ الوسط الذي تتحرك فيه المواهب – وبعضها على مستوى رفيع من الفرداة – غير مؤهل لهضم كل هذا النتاج، فما بالك بفرزه وتمييزه وفق معايير جَمالية وأحكام قيمة محايدة!