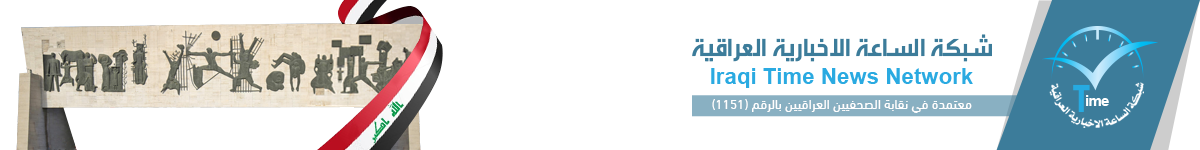الكتابة فن حي يصعب تطوره بدون التفاعل مع نماذج مجاورة له زمناً ومكاناً»… العراقي مرتضى كزار: الرواية بنت التفكير والهيام العميق بعالمك الخاص
أكبر» جعلت منه اسماً لامعاً في عالم السرد العراقي، هذه الرواية التي
أثارت إشكاليات كثيرة للكاتب والسينمائي مرتضى كـزار، إذ عدَّها البعض تحمل
بعداً دينياً أو طائفياً، في حين أنه اشتغل فيها على الوثيقة وتحولاتها من
خلال عائلة نجفية.
كـزار (البصرة 1982) تخرج في كلية الهندسة، غير أن
انشداده لكتابة الرواية غيرت مجرى حياته، ليدخل بعد ذلك إلى عالم السينما،
ويشارك فيلمه «رب اغفر لنديمة» في مهرجان دبي للأفلام القصيرة، وبانتظار
عرض فيلمه الجديدة «الكعب الذي رأى»، فضلاً عن ذلك فهو كاتب قصة قصيرة
بنموذجها الخاص به، إلا أنه لم يقتنع حتى الآن بإصدار كتاب قصصي، معترفاً
بأن كل هذه الفنون بالنسبة له تأتي ثانياً بعد عالم الرواية الذي لا يريد
أن يخرج منه.
عن أعماله وحياته كروائي ومخرج سينمائي، كان لنا معه هذا الحوار:
■ ثلاثة عوالم روائية أدخلتك بقوة إلى السرد العراقي، على الرغم من صغر
سنك حين أصدرت «صفر- واحد»، ألا ترى أن الدخول مباشرة إلى الفن الروائي ليس
بالأمر اليسير؟ وكيف تمكنت من تركيب عالم كمبيوتري ومن ثم تجميع أعواد
مكنسة الجنة ثم «السيد أصغر أكبر»؟
□ نشرت صفر- واحد، كمبيوتريا سنة
2006، كنت في بداية العشرين ولم أكن قد تعرفت بشكل كافٍ على فن الرواية،
بالأحرى.. لم أكن أعرف إن ما أكتبه كان رواية وأتذكر بأنني لم أقرأ في
السرد غير أشياء تراثية كانت في مكتبة الأسرة كـ»التوابع والزوابع» و»كليلة
ودمنة» و»رسالة الغفران»، كنت أعمل مصمما في مطبعة فقيرة بمنطقة
البتاويين، وهي المطبعة نفسها التي كنت أجمّع منها ما يفضل من الورق
والأصباغ لطباعة ذلك الكتاب.
ما يجعلني أتصور الآن هو أن حاجتي لتلك
الكتابة كانت غريزية وغير مثقفة، هو استثماري لها أحياناً لحاجاتي كمراهق،
لقد كتبت قصصاً إيروتيكية كثيرة لتأسيس كوني المسلي الخاص، وما زلت أرى أن
سبب نشر روايتي الأولى لم يكن حقيقياً، كنت مغرماً بتلك الروابط المعقدة
بين العوالم الرقمية والتأريخ، بين الإنسان المسجون داخل أحلامه المتعالية
وما يحيط به من وقائع طاردة لجنونه وأمنياته، كل هذا يجعلك اليوم تحاول أن
تبدو متوازناً بين الدفق الأول وروحية المكتوب الأول والخروج إلى لغة لا
تعبر عنك وعن عزلتك؛ بل تشي بما يحيط بك أيضاً.
لم أعد أرى ما كان يفعله
الصبي الذي نشر روايته ضرورياً ونافعاً، لم أعد أعتز بذلك، الحياة تغيرت
ووسائل التعبير اختلفت، لم تعد الكتابة السردية؛ مثلاً، طريقة فاضلة ومثلى
في القول والتفكير وتخليق الآراء، علينا دائماً أن نتشجع لقول ذلك. لقد
تنافذ السرد مع الفنون الجديدة وصارت حتى طرائق التلقي شبيهة بعالم
الكمبيوتوبيا.
■ في روايتك «السيد أصغر أكبر» ابتعدت كثيراً عن مدينتك
البصرة، وهو ما اشتغلت عليه في «مكنسة الجنة» وذهبت بعيداً حيث النجف،
لماذا تلك المدينة؟ وما الذي في هذه الرواية لكي تأخذ صدى كبيراً وسط زحمة
الإصدارات الروائية العراقية؟ السؤال الأهم: ما العوامل الداخلية والخارجية
التي تجعل من عمل ناجح وله جمهوره دون عمل آخر؟
□ الذي يولد على ضفاف
نهر صغير اسمه شط الأمير قبل خمس دقائق من التحامه بشط العرب، يدرك أن
البصرة تنتمي إلى اللامكان المتخيل، ولكي لا تبدو هذه عبارة أدبية جداً..
البصرة مدينة غرباء بامتياز، لقد أصبحت كذلك في العقود الخمسة أو الستة
الأخيرة، العيش فيها لا يمنحك رسماً من ملامحها وخصوصياتها، حينما سكنت في
بغداد لدراسة هندسة البترول، يجيبني الكثير من المجانين والمشردات في
الشوارع الفقيرة بأنهم من البصرة، البصرة بالنسبة لهم مدينة كذبة يلجأون
لها حتى لو كانوا من أحياء قريبة، مركزيتها الرومانسية تستر قصصهم الجامحة
والكابوسية، وجبنها الناتج عن تأنيث السلطات لها يجعلهم يفترون عليها براحة
بال، يمكنك أن تشير إليها بإصبعك، لكن يصعب عليك لمسها وتحديد سحنات أهلها
ولهجاتهم المتعددة، ولأنها مهملة من قبل المحراث الثقافي العراقي، فما
تزال قارة غير مكتشفة، غير أن ما أردت قوله في «مكنسة الجنة» هو غير ما
أردت قوله في «السيد أصغر أكبر».
في «مكنسة الجنة» توثيق شخصي لطفولة
غائرة أيضاً عملت خلالها كجامع للشظايا في الفاو، كانت مهنة مربحة نسبياً
للصبيان في التسعينات خلال الحصار، أظن أن مشغل مكنسة الجنة كله جاء من تلك
الفترة، أما «السيد أصغر أكبر» فهي عن حقبة أخرى، لحظة بزوغ لبؤرة تحول
فارقة في السلطة المعنوية، يشبه الأمر تلك الحركة الداخلية التكتونية
لصفائح الأرض وتبادل المدن لمركزياتها، أو تنقل كرة اللعب من قدم إلى أخرى،
والنجف من المدن الكاشفة لجزء كبير من الحياة العراقية، ومكان الرواية، كل
رواية، هو المحلول المذيب الذي يفسر طبائع وروائح ومذاقات الشخوص الذائبة
فيه، مثل أي سائل ممغنط يفكك الجزيئات ويكشف التفاعلات والسمات الحية
للعناصر الداخلة إليه.
لا أعرف تحديداً إن كانت هنالك عوامل محددة لنجاح
عمل أدبي ما، من يقوى على الحكم والتنبؤ بذلك، حتى لو تلخص الأمر بمدى
أهمية ما يقوله هذا العمل أو مدى خطورة الحكاية أو الفكرة التي يتناولها؛
فهذا ليس بكافٍ، ذلك لأننا في الغالب نتوهم أهمية ما نقول ونصاب بوهم
الأهمية إزاء أشياء عادية وساذجة.
■ خلال السنوات الماضية، اشتهرت
الكثير من الأعمال الروائية باستخدامها (الوثيقة) والبناء التاريخي منطلقاً
لتقنياتها السردية، كذلك أنت اشتغلت على ذلك، في إبراز التزوير وإدخاله في
عملك «السيد أصغر أكبر»، لماذا هذه العودة للتاريخ؟ وكيف يمكن إسقاطه على
واقعنا الراهن؟
□ كل رواية هي تأريخ، والعكس وعكسه صحيحان أيضاً، حتى
الروايات في عهود مستقبلية أو عهود لم تحدث أصلاً هي نحو من التاريخ الذي
ليس له معنى، وهذه النتيجة نفسها تنتهي إليها حتى الروايات التأريخية التي
تتلبس التأريخ بوقائعه الحقيقية، فالناتج دائماً هو مزج بين ما حدث وما لم
يحدث أبداً، بين شخصيات مهمة وأخرى هامشية، حقن الهامشي بقوة ظهور وتمتين،
وحقن المهم والمشهور من الشخوص والأماكن بمثبطات تحبسه في الهامش، وهكذا،
فالناتج من الوثيقة في الرواية هو شيء غير موجود، لأن التخييل مثل الرقم
صفر، حاصل ضربه مع أي شيء حقيقي هو صفر أيضاً.
التواريخ مثل إنطاق
الهدهد أو السلحفاة في القصص، الهدف هو الحصول على فوائد المغزى والعبرة
والموعظة، ومع تطور الفن السردي أصبح الهدف هو الحصول على شبه المغزى وشبه
العبرة وشبه الإمتاع، لكن قوة التواريخ في الرواية تتجلى حينما تمر على
مناطق متعطشة للمراجعة ومصابة بالتلفيق والجدل والتدوين المشكوك المضبب
بملاحم وفتن ونزاعات عرقية وطائفية. قرأت أكثر ما كتب عن النجف حتى عام
2011، واستثمرت ما ادخرته في ذاكرتي خلال فترة إقامتي هنالك أيام الدراسة
الدينية، حتى تنبهت إلى أن الحصيلة التي في عقلي يمكنها أن تتحول إلى
رواية، ويبدو أن هناك درجة مثل درجة الاحتراق أو الانجماد والتبخير تتحول
عندها المعارف إلى روايات. كنت بحاجة إلى تأثيث خيالي أولاً قبل خيال النص،
أتممت النص ونشرته مباشرة من دون تروٍ أو تأخير، لقد كلفني هذا طريقة نشر
غير مرضية، ودائرة من سوء الفهم قوبل بها النص، لأن هناك تصوراً استباقياً
عن أي نص يتناول مدينة مقدسة، كان هناك من يبحث عن كاتب ليجلده أو يكفره،
ولقد كانت هذه مهمة صعبة، لأن النص ليس فيه ما يغضب أو يسيء.
■ هناك من
يزيل التراب عن موضوعة رواياته ويعيد بنائها من جديد، من خلال نماذج تمر
به بشكل يومي، وهناك من يعيد بناء الحجر ويحفر أخاديده بإزميل لم يستخدمه
أحد قبله، فيضع لنفسه خريطة يعيد من خلالها بناء عمله الروائي… أين تجد
موضوعاتك؟ وكيف تعيد نحتها ضمن تقنيات سردية خاصة بك؟
□ يجيب كالفينو
عن سؤال الكيف في الكتابة، بجملة: أكتب بيدي، بمعنى، كيف تكتب يا كالفينو،
يجيب: أكتب بيدي، وهذا من وجهة نظر غير متحذلقة ومتعالية على نوازع الكتّاب
في تلوين صورهم؛ جواب العارف المشغول بفنه، أؤمن أن الرواية بنت التفكير
والهيام العميق بعالمك الخاص، بنت الشغف بالمشغل الفرداني والآراء الحادة
والمجافية لعالمنا الموحش بانحطاطه وقذارته وظلاماته.
هذا هو المنطلق
والدافع والمحرك، بعد ذلك، أشعر بأن عليّ دائماً أن أتخيّر لآرائي هيكلاً
وعمارة تصلح لها، أختار العمود الفقري المناسب للسمكة التي سأطلقها في
المحيط. وأعتقد أن الكتابة في الرواية والقص السينمائي متورطان بتناول
أشباه الموضوعات لا الموضوعات حسب التعبير الفلسفي، وأمامها يسقط سؤال
الثيمة المحددة والتناول المخصص، حتى في لحظات التأمل النقدي يصعب في
الأعمال الفنية الركون إلى مغزى واحد محدد، لذلك أفشل دائماً أمام سؤال
الموضوع والمقولة التي أنوي التعريض بها داخل العمل، ولست ممن يظن أننا
نعيش في بيئة ثرية والحكايا ملقاة على الطرقات، هذه العبارات ليست على
طاولتي، الكاتب مثل من يمتلك حنجرة مدربة وجاهزة للغناء حتى في كأس مفرغّة
من الهواء، والكتابة فن حي يصعب أن يتطور بدون أن يتفاعل مع نماذج عريقة
مجاورة له زمناً ومكاناً.
■ دخلت إلى عالم السينما بعد مسيرة ليست
بالقصيرة في السرد، وشاركت في مهرجان دبي السينمائي بفيلمك «رب اغفر
لنديمة» لماذا السينما؟ وما الذي أضافته لك في عالمك الروائي؟ وما الذي
صنعته في هذا الفيلم لتبدأ مشاريع جديدة لم تعلن حتى الآن؟
□ في
القاهرة، عرفني أصحابي المصريون إلى الآخرين كمخرج سينمائي، كنت أضحك في
سري. في مهرجان دبي السينمائي وجدت نفسي مغترباً تماماً أحاول إرجاع كل
الأسئلة والحوارات إلى طاولة الروائي بدون جدوى، والشعور نفسه حاكم لموقع
التصوير الذي لا يخضع لظروف النتاج والتصوير السينمائي التقليدية، لأنني
كنت أوفى لطقس الكاتب خلف الكاميرا وحواليها. أحببت في السينما كونها
مزيجاً مثل الرواية بين فنون عديدة، كما أنها تصنع وهماً سينماتوغرافيا كما
يقول برجسون، هذا الوهم يشبه الوهم الذي أعمد على تصنيعه في الكتابة، في
طفولتي عملت طويلاً على خياطة الدمى وتحريكها، إرغامها على النطق وبثها في
حكاية ما، ولعلي سأعود لذلك في يوم ما. فيلمي القصير الأول من ناحية الهم
يشبه ما كتبته في رواية «مكنسة الجنة»، لكن حكايته تدور حول الموسيقى في
حياتنا، أتاحت لي صناعة السينما الفتية في العراق أن أتعرف على وسط ناشئ ما
تزال علاقته ضعيفة بحركة القص السردي في العراق، ولقد تأخر هذا الاتصال
طويلاً، لدرجة أن السينما عندنا لم تستفد من القص ولم يحدث العكس كذلك،
تابعت هذا الفصام وكتبت عنه وأرغب أن تعود هذه الفنون إلى المجاورة كما
يحدث في العالم البالغ سينمائياً.
قمت بالتصوير بنفسي في فيلمي الثاني
«الكعب الذي رأى» ولعلي سأفعل ذلك في كل ما أخرجه للسينما في مقبل الأيام،
يصعب طبعاً القبض على كل هذه المهام لكن المحاولة نافعة. في الخطة مشاريع
كثيرة، أتمنى أن أنجز فيلمي الطويل الذي فرغت من كتابته هذه الأيام «طائفتي
الجميلة».
■ بدأ الكثير من الروائيين العراقيين والعرب يخيطون أعمالهم
على قياس الجوائز، حتى أن هناك كتاباً يحدد بأنه سـ(يكتب) عملاً ليشارك به
في جائزة معينة؛ إلى أي مدى تمكنت الجوائز العربية من رسم طريق لكتابنا؟
وهل تمكنت فعلاً من تطوير التقنيات والأساليب الفنية للرواية العربية؟
□
الجوائز ليست مرقاباً جيداً لكشف الجيد السمين بلطائفه ومبتكراته في
عالمنا العربي، نهائياً، وجل ما أنتجته رؤوس الأموال المتثاقفة هذه هي
الترويج الجيد للكتب والكتّاب، وهذا حسن في حال من الأحوال، قد يولد دافعاً
جديداً للقارئ العربي الفقير في مكتبته، لكنه قد يشكل خطورة في التضليل
القرائي وتركيب ذائقة هجينة وغير حقيقية عن آخر مثابات القص العربي
وتطوراته، على أن الجوائز قد ردت بعض الاعتبار المستحق للكثير من المبدعين
العرب وأسبغت عليهم مكانتهم اللائقة.
لا يجدي طبعاً تلبيس الأعمال على
مقاسات الجائزة، الكاتب هو الذي يخلق المقاسات ويفتتح المتاهات والطرق
الوعرة التي لم تبلغها الأقدام، الكتابة المتتبعة لمجسات التقدير والجائزة
لا تعمر طويلاً وهي بطبيعة الحال مبتغى سهل وأمنية صغيرة جداً.
■ على
الرغم من انهماك العالم العربي عموماً والعراقي على وجه الخصوص بالفن
الروائي، إلا أنك بدأت بالاشتغال في عالم القصة القصيرة، عالم تمزج فيه بين
السرد والكاميرا السينمائية. هل كنت بحاجة لهذا الفن الصعب؟ وكيف يمكن أن
تتخلص في كتابتك فيه من عالم السرد الروائي إلى السرد القصير؟
□ بدأ
الأمر أشبه بتمرينات في الضبط والشكل واللغة، كان دخول هذه المغارة سهلاً
مع نصوص لن أنشرها أبداً، ثم تجلت صعوبته مع التوغل أكثر، أحببت تجريب تلك
الصعوبة، لأنني بدأت مع السرد المطوّل، وللأمر صلة طبعاً بالشروع
بسيناريوهات أفلام قصيرة، والخلاصة أن الوفاء الكامل لنوع من تلك الفنون
المتجاورة ليس أصيلاً، والرابط بينهما هو حرفة تخليق الشخوص وترسيم
الحكايات، لقد ساعدني التنقل بينها في تخليص السرد مثلاً من عوالق اللغة،
وفي تحلية اللقطة بمقادير درامية وحكائية واضحة. لهذا جعلني صبوراً، وهي
الفضيلة التي كانت تنقصني في معضلة تربية الحكايات والعوالم في فن الرواية.